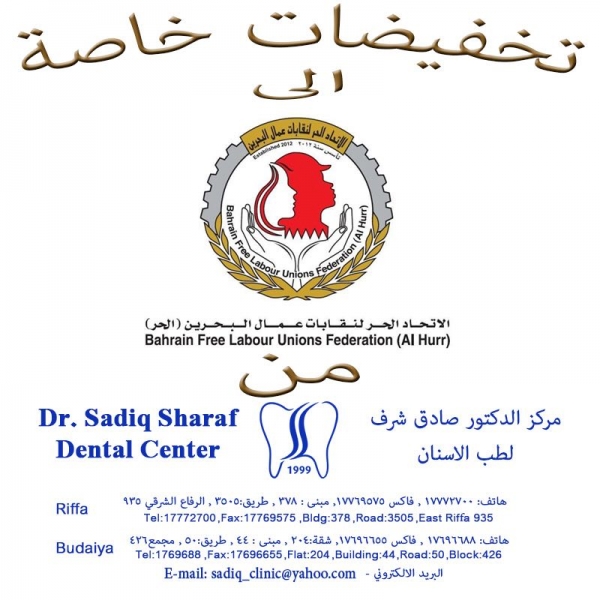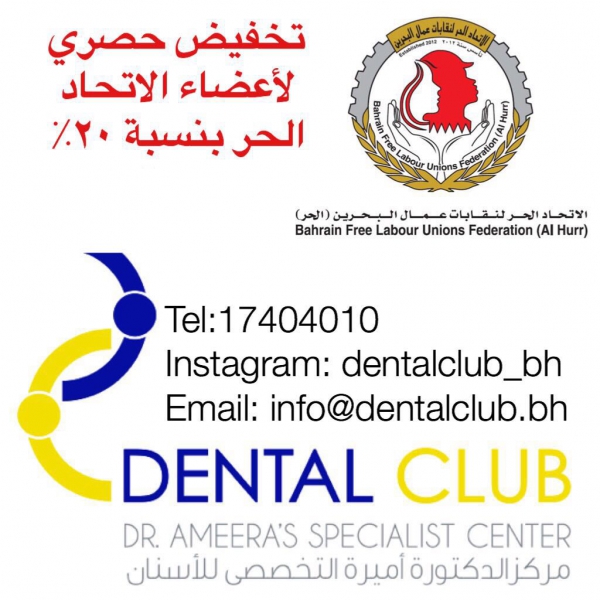عن الولاء والرضا الوظيفي
عن الولاء والرضا الوظيفي
بقلم: د. زكريا خنجي
نعرف أن العمل يعد جزءا مهما من حياة الإنسان، وداخل منظومة العمل يقضي الإنسان الجزء الأكبر من حياته، من حيث المساحة الزمنية، وحتى بعد أن يترك العمل في نهاية اليوم فإن تلك الفترة تظل قابعة في وجدانه إلى أن يعود إليها في اليوم الثاني، فهي التي تشكل في قلبه الرضا والسخط، المعتقدات والمشاعر، المعرفة والخبرة. وبمرور الوقت يصبح هذا الإنسان جزءا من هذه المنظومة، وفردا من المجموعة، وبناء على اندماج الفرد مع هذه المنظومة يتشكل وجدانه ومشاعره من ناحية عمله، وبالتالي يميل الفرد الى أن يتصرف سلوكيًا ناحية عمله بشكل معين يظهر في أسلوب تعامله مع الزملاء، في غيابه وتأخره، وفي تركه للعمل، وفي طريقة احترامه لرئيسه وزملائه ولأنظمة المؤسسة، عندئذ يتولد في نفس الإنسان ما يعرف «بالرضا الوظيفي»، وبالتالي يصبح لديه ولاء للمؤسسة وللأفراد الذين يعيش معهم ويتعايش. فما الرضا الوظيفي؟ وكيف ننمي الرضا الوظيفي ليصبح ولاءً للمؤسسة؟ ونحن نقلب الأدبيات المتعلقة بالرضا الوظيفي وجدنا العديد من التعاريف والمصطلحات، ولكننا - كعادة - سنحاول أن نلخص بعضًا من تلك التعريفات، مثل: يشير معجم التراث الأمريكي إلى أن الرضا هو «تحقيق، إشباع رغبة أو حاجة، شهوة أو ميل». كما عرف المعجم السلوكي (ولمان) الرضا بأنه «حالة السرور لدى الكائن العضوي عندما يحقق هدف ميوله الدافعية السائدة»، ونجد أيضًا تعريفا آخر للرضا بأنه «إحساس الفرد بالرضا بعد أن يكون قد حقق رغبته أو حاجته أو طموحه ووصل إلى الذي كان يسعى لبلوغه».
أما الرضا من وجهة نظر الباحثين في المجالات التي تهتم بالعنصر البشري في المؤسسة فيعرف كما يلي: «تقبل العامل لعمله من جميع ظروفه وشروطه ونواحيه، وأن يعكس هذا الرضا شعور العاملين تجاه ما يقومون به من أعمال، وإن حالة الرضا هنا تؤدي إلى مزيد من الإنتاج المصحوب بالتوتر السوي (الإيجابي)، أما عدم الرضا فيؤدي إلى التوتر السلبي، غير السوي وضعف الحافز للإنتاج». كما يعرف على أنه «هو الحالة النفسية أو الانفعالية السارة التي يصل إليها الموظف، عند درجة إشباع معينة، تحدث له جراء تعرضه لمجموعة من العوامل النفسية، الاجتماعية، المهنية والمادية».
كذلك يعرف على أنه «المشاعر التي تعبر عن مدى إشباع الحاجات التي يتصور الفرد أنه يحققها من العمل، فكلما كان هذا التصور إيجابيًا كانت مشاعر العامل نحو عمله إيجابية، أي أنه يكون راضيًا عن هذا العمل، فدرجة الرضا تمثل سلوكا يكمن في وجدان الفرد، وتبقى مشاعره حبيسة نفسه، أو تظهر في سلوكه الممارس». إذن يمكن أن نلخص كل تلك التعاريف والكثير من التعاريف الأخرى في قولنا بان الرضا يمكن أن يكون درجة إشباع حاجات الفرد، على أن يتحقق هذا الإشباع من عوامل متعددة منها ما يتصل بالعمل ذاته، ومنها ما يتصل بالبيئة، وما يتصل بالفرد ذاته، وكل تلك العوامل من شأنها أن تجعل الإنسان راضيًا عن عمله محققًا لطموحاته ورغباته وتطلعاته وميوله المهنية ومتناسبًا مع ما يريده الفرد من عمله وبين ما يتحصل عليه في الواقع أو يفوق توقعاته منه.
لذلك نعتقد أن الرضا وبالتحديد الرضا الوظيفي يعد من الموضوعات المهمة للأفراد والمجتمعات، فهو الأساس الذي يحقق التوافق النفسي والاجتماعي للعاملين، ويساعد على حسن الأداء، لارتباطه بالنجاح في مجال العمل. كما يعد المعيار الموضوعي لنجاح الفرد في مختلف جوانب حياته، والذي ينعكس على سلوكه من خلال اتجاهاته الكامنة وعلى قوة المشاعر لديه ودرجة تراكمها. ففي هذه الحالة يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله فيصبح إنسانًا تستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها من خلال طموحه الوظيفي ورغبته في النمو والتقدم، وتحقيق أهدافه الاجتماعية من خلالها، ويمكن تسمية الفرد حينئذ بالشخص المتكامل. والعكس يمكن أن يحدث، فإنه كلما زادت قوة استيائه من العمل فإن ذلك يظهر على سلوكه، فإما أن يترك العمل ويبحث عن عمل آخر وإما تزيد نسبة غيابه أو تسربه من العمل. وفي هذه الحالة فنحن أمام شخصين، وهما: إما شخص غير متكامل مع وظيفته، وهو الذي ينظر إلى عمله على أنه وسيلة يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف المهنية دون الاهتمام بتنمية مسؤولياته أو تحقيق استقلالية، أو شخص محايد، وهو الذي يكون ارتباطه بوظيفته وعمله بالقدر الذي يجنبه المساءلة والمسؤولية. ولا يمكن حصر كل الدراسات التي أجريت حول الرضا الوظيفي سواء في العالم أم بالتحديد في دول الخليج العربي، فمثلاً تشير التقارير الى أنه في عام 1976 وحده أجريت أكثر من 3350 دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية تناولت فقط موضوع الرضا الوظيفي. وهذا العدد الهائل من الدراسات إن كان يشير إلى شيء فإنها تشير إلى أهمية هذا الموضوع الذي يجب الاهتمام به. في دراسة عبيد عبدالله العمري (1992) بعنوان: «بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الولاء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل على الأداء الوظيفي والفعالية التنظيمية» اتضح أن متغير الرضا الوظيفي يتحدد بكل من العمر والخدمة والراتب الشهري وصراع الدور وغموض الدور ومتغير الأداء الوظيفي. وأما دراسة راشد السهل حسن الموسوي (1995) عن «الرضا الوظيفي عند المرشد التربوي في مدارس الثانوية للمقررات في دولة الكويت» فتوصلت الى أنه يجب إعادة النظر في نظام الحوافز والعلاوات والرواتب المتعلقة بوظيفة المرشد التربوي، والعمل على توفير مكان مناسب لاستقبال الحالات وحفظ الملفات لتحقيق السرية في المجتمع المدرسي لوظيفة المرشد التربوي، بالإضافة إلى العمل على تحديد التوصيف المناسب لوظيفة المرشد التربوي بحيث تكون أكثر وضوحًا، كما أشار العديد من المرشدين الى أنه بحاجة إلى تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وزيادة معلوماتهم.
أوضحت دراسة نواف بن عبدالله جدعان المدهرش الرويلي (2001) حول «الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات مدارس التعليم العام الحكومي بمنطقة الحدود الشمالية» أن هناك مجموعة من العوامل يرى مديرو ومديرات المدارس أنها معوقات للرضا الوظيفي لديهم أهمها: عدم أخذ المسؤولين برأي مديري ومديرات المدارس أثناء تعيين معلمين ومعلمات جدد في المؤسسة، عدم استطاعة مديري ومديرات المدارس توفير قسط كبير من الراتب لتلبية احتياجات المستقبل، عدم توفر المتطلبات المادية اللازمة في العمل، المكافآت المادية والامتيازات المرتبطة بالعمل، عدم تعاون أولياء الأمور في خدمة أهداف المؤسسة، وعدم العدالة في استحقاقية منح الترقية.
عمومًا، هذه بعض الأمور المتعلقة بالرضا الوظيفي، ولكن يبقى السؤال الأهم كيف يمكن تنمية هذا الرضا وتحويله من سخط إلى رضا في المؤسسات بعيدًا عن الراتب والأمور المالية، فهل يمكن ذلك؟
أما الرضا من وجهة نظر الباحثين في المجالات التي تهتم بالعنصر البشري في المؤسسة فيعرف كما يلي: «تقبل العامل لعمله من جميع ظروفه وشروطه ونواحيه، وأن يعكس هذا الرضا شعور العاملين تجاه ما يقومون به من أعمال، وإن حالة الرضا هنا تؤدي إلى مزيد من الإنتاج المصحوب بالتوتر السوي (الإيجابي)، أما عدم الرضا فيؤدي إلى التوتر السلبي، غير السوي وضعف الحافز للإنتاج». كما يعرف على أنه «هو الحالة النفسية أو الانفعالية السارة التي يصل إليها الموظف، عند درجة إشباع معينة، تحدث له جراء تعرضه لمجموعة من العوامل النفسية، الاجتماعية، المهنية والمادية».
كذلك يعرف على أنه «المشاعر التي تعبر عن مدى إشباع الحاجات التي يتصور الفرد أنه يحققها من العمل، فكلما كان هذا التصور إيجابيًا كانت مشاعر العامل نحو عمله إيجابية، أي أنه يكون راضيًا عن هذا العمل، فدرجة الرضا تمثل سلوكا يكمن في وجدان الفرد، وتبقى مشاعره حبيسة نفسه، أو تظهر في سلوكه الممارس». إذن يمكن أن نلخص كل تلك التعاريف والكثير من التعاريف الأخرى في قولنا بان الرضا يمكن أن يكون درجة إشباع حاجات الفرد، على أن يتحقق هذا الإشباع من عوامل متعددة منها ما يتصل بالعمل ذاته، ومنها ما يتصل بالبيئة، وما يتصل بالفرد ذاته، وكل تلك العوامل من شأنها أن تجعل الإنسان راضيًا عن عمله محققًا لطموحاته ورغباته وتطلعاته وميوله المهنية ومتناسبًا مع ما يريده الفرد من عمله وبين ما يتحصل عليه في الواقع أو يفوق توقعاته منه.
لذلك نعتقد أن الرضا وبالتحديد الرضا الوظيفي يعد من الموضوعات المهمة للأفراد والمجتمعات، فهو الأساس الذي يحقق التوافق النفسي والاجتماعي للعاملين، ويساعد على حسن الأداء، لارتباطه بالنجاح في مجال العمل. كما يعد المعيار الموضوعي لنجاح الفرد في مختلف جوانب حياته، والذي ينعكس على سلوكه من خلال اتجاهاته الكامنة وعلى قوة المشاعر لديه ودرجة تراكمها. ففي هذه الحالة يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله فيصبح إنسانًا تستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها من خلال طموحه الوظيفي ورغبته في النمو والتقدم، وتحقيق أهدافه الاجتماعية من خلالها، ويمكن تسمية الفرد حينئذ بالشخص المتكامل. والعكس يمكن أن يحدث، فإنه كلما زادت قوة استيائه من العمل فإن ذلك يظهر على سلوكه، فإما أن يترك العمل ويبحث عن عمل آخر وإما تزيد نسبة غيابه أو تسربه من العمل. وفي هذه الحالة فنحن أمام شخصين، وهما: إما شخص غير متكامل مع وظيفته، وهو الذي ينظر إلى عمله على أنه وسيلة يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف المهنية دون الاهتمام بتنمية مسؤولياته أو تحقيق استقلالية، أو شخص محايد، وهو الذي يكون ارتباطه بوظيفته وعمله بالقدر الذي يجنبه المساءلة والمسؤولية. ولا يمكن حصر كل الدراسات التي أجريت حول الرضا الوظيفي سواء في العالم أم بالتحديد في دول الخليج العربي، فمثلاً تشير التقارير الى أنه في عام 1976 وحده أجريت أكثر من 3350 دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية تناولت فقط موضوع الرضا الوظيفي. وهذا العدد الهائل من الدراسات إن كان يشير إلى شيء فإنها تشير إلى أهمية هذا الموضوع الذي يجب الاهتمام به. في دراسة عبيد عبدالله العمري (1992) بعنوان: «بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الولاء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل على الأداء الوظيفي والفعالية التنظيمية» اتضح أن متغير الرضا الوظيفي يتحدد بكل من العمر والخدمة والراتب الشهري وصراع الدور وغموض الدور ومتغير الأداء الوظيفي. وأما دراسة راشد السهل حسن الموسوي (1995) عن «الرضا الوظيفي عند المرشد التربوي في مدارس الثانوية للمقررات في دولة الكويت» فتوصلت الى أنه يجب إعادة النظر في نظام الحوافز والعلاوات والرواتب المتعلقة بوظيفة المرشد التربوي، والعمل على توفير مكان مناسب لاستقبال الحالات وحفظ الملفات لتحقيق السرية في المجتمع المدرسي لوظيفة المرشد التربوي، بالإضافة إلى العمل على تحديد التوصيف المناسب لوظيفة المرشد التربوي بحيث تكون أكثر وضوحًا، كما أشار العديد من المرشدين الى أنه بحاجة إلى تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وزيادة معلوماتهم.
أوضحت دراسة نواف بن عبدالله جدعان المدهرش الرويلي (2001) حول «الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات مدارس التعليم العام الحكومي بمنطقة الحدود الشمالية» أن هناك مجموعة من العوامل يرى مديرو ومديرات المدارس أنها معوقات للرضا الوظيفي لديهم أهمها: عدم أخذ المسؤولين برأي مديري ومديرات المدارس أثناء تعيين معلمين ومعلمات جدد في المؤسسة، عدم استطاعة مديري ومديرات المدارس توفير قسط كبير من الراتب لتلبية احتياجات المستقبل، عدم توفر المتطلبات المادية اللازمة في العمل، المكافآت المادية والامتيازات المرتبطة بالعمل، عدم تعاون أولياء الأمور في خدمة أهداف المؤسسة، وعدم العدالة في استحقاقية منح الترقية.
عمومًا، هذه بعض الأمور المتعلقة بالرضا الوظيفي، ولكن يبقى السؤال الأهم كيف يمكن تنمية هذا الرضا وتحويله من سخط إلى رضا في المؤسسات بعيدًا عن الراتب والأمور المالية، فهل يمكن ذلك؟
zkhunji@hotmail.com @Z_khunji