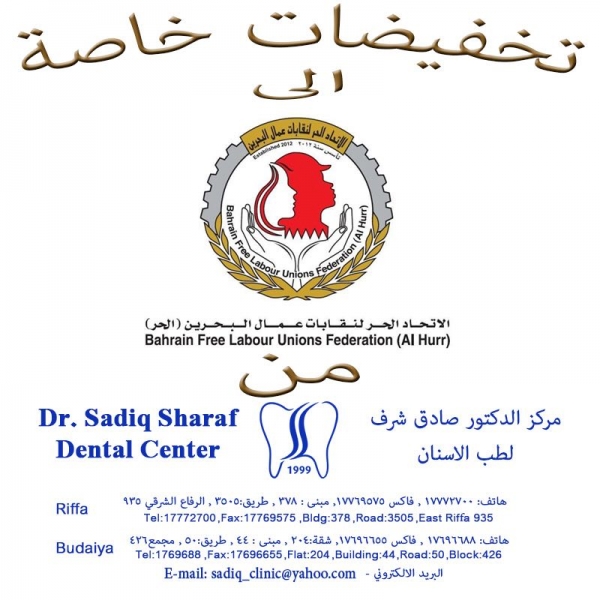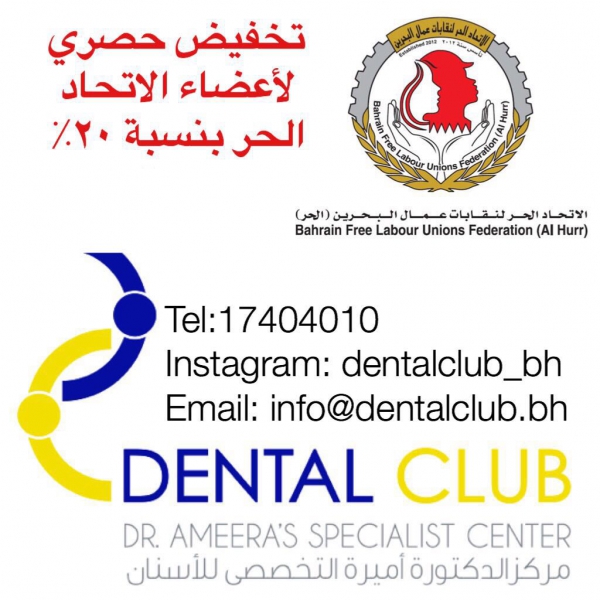لماذا يجب أن نهتم بالرضا الوظيفي في مؤسساتنا؟
لماذا يجب أن نهتم بالرضا الوظيفي في مؤسساتنا؟
بقلم: د. زكريا خنجي
قلنا في المقال السابق إن الرضا الوظيفي يعد من الموضوعات المهمة للأفراد والمجتمعات، فهو الأساس الذي يحقق التوافق النفسي والاجتماعي للعاملين، ويساعد على حسن الأداء، لارتباطه بالنجاح في مجال العمل. كما يعد المعيار الموضوعي لنجاح الفرد في مختلف جوانب حياته، والذي ينعكس على سلوكه من خلال اتجاهاته الكامنة وعلى قوة المشاعر لديه ودرجة تراكمها.
وقلنا أيضًا إنه في هذه الحالة يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله فيصبح إنسانًا تستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها من خلال طموحه الوظيفي ورغبته في النمو والتقدم، وتحقيق أهدافه الاجتماعية من خلالها، ويمكن تسمية الفرد حينئذ بالشخص المتكامل. إلا أننا لم نوضح الآثار – الإيجابية والسلبية – المترتبة على الإنسان من الرضا أو فقد الرضا الوظيفي. لذلك سنحاول اليوم أن نلقي ولو بصيصا من الضوء حول هذه الآثار، فإن ذلك حتمًا سيقودنا إلى طرح موضوع كيف يمكن أن ننمي الرضا الوظيفي عند الفرد ليصبح لديه الولاء المؤسسي وليس الولاء النرجسي.
أولاً: الآثار السلبية لعدم الرضا الوظيفي آثار سلبية على المؤسسات، والتي تظهر من خلال الغياب، دوران العمل والتمارض، الإصابات، الشكاوى، الإضراب واللامبالاة. 1- الغياب: يعرف الغياب عمومًا على أنه «نقص الملازمة في العمل الذي يتطلب الحضور الدائم، وأسبابه عديدة تتمثل في: المرض، عطل الأمومة، حوادث العمل، عطل لأسباب عائلية أو إدارية، عطل غير موافق عليها أو التكوين خارج المنظمة. وقد تم تقسيم عوامل الغياب إلى عوامل شخصية وأخرى مهنية. وقد أكدت العديد من الدراسات وجود علاقات قوية بين عدم الرضا الوظيفي ومعدل الغياب، وأن ارتفاع مستوى الرضا يؤدي إلى انخفاض نسبتي التغيب والتسرب».
2- دوران العمل: ويعني ترك العمل عن استقالة العامل من المؤسسة طواعية، وهذه الاستقالة لها مجموعة من التكاليف تتحملها المؤسسة كتكلفة الإحلال، تكلفـة التدريب، وتكلفة التعيين والتي تزداد كلما ارتقينا في السلـم أو الهرم التنظيمي، بالإضافة إلى أن المنظمة تتحمل تكاليف أخرى غير ملموسة (التكاليف الخفية في الموارد البشرية) مثل تشتت جماعة العمل التي يعمل بها هذا الفرد المستقيل، وتعظم التكاليف أكثر إذا كان تارك العمل من ضمن الأفراد ذوي الأداء والخبرات العالية. ويقود التفكير المنطقي إلى افتراض أنه كلما زاد رضا الفرد الوظيفي، زاد الدافع لدى الموظف إلى البقاء في هذا العمل، وقل احتمال تركه للعمل بطريقة اختيارية، ولقد أجريت عدة دراسات تهدف إلى اختبار صحة هذا الفرض، فأظهرت بدرجات متفاوتة أن هناك علاقة سلبية بين الرضا ومعدل دوران العمل، بمعنى كلما ارتفعت درجة الرضا الوظيفي يميل معدل دوران العمل إلى الانخفاض.
3- التمارض: أي ادعاء المرض، وهي ظاهرة تعبر في الغالب عن عدم رضا العامل؛ وذلك من خلال الضغط النفسي الذي يواجهه داخل المؤسسة أو خارجها، ويلجأ العامل إلى الحالات المرضية المقنعة للابتعاد عن محيط العمل تهربًا من الواقع المعيشي فيها أو للتقليل من الانعكاسات السلبية التي يواجهها أثناء عمله.
4- الشكاوى: أظهرت بعض الدراسات أن ارتفاع الشكاوى والتظلمات تظهر كثيرًا في المؤسسات التي يغلب عليها عدم الرضا عن نمط الإشراف، فالعامل يستعمل وسيلة التظلم والشكوى كآخر إجراء للتعبير عن تذمره تجاه الأسباب التي جعلته في حالة عدم رضا عن عمله أو عن غيرها، بهدف جلب اهتمام المشرفين والإداريين لدراسة وضعيته.
وبغض النظر عن موضوعية هذه الشكاوى من عدمها، فإن المؤسسة مطالبة بالاهتمام بها ودراستها وتحليلها بدقة من أجل تفادي الاضطرابات والتوترات التي قد تظهر وتؤثر سلبًا على أدائها.
5- اللامبالاة والتخريب: المسؤولون عادة يحافظون على صيانة الآلات من الأعطال كي لا تؤثر على سلامة المنتجات وتجهيزات المؤسسة، غير أنهم لا يدركون أن حجر الزاوية في المؤسسة هو العامل، وأن انخفاض درجة الرضا ينعكس على مدى اهتمامه وانضباطه أثناء تأديته لواجباته مما ينجر على ذلك وقوعه في حالات من الإهمال واللامبالاة اللذين يؤديان بدورهما إلى قيام العامل بتخريب أدوات الإنتاج، أو حتى إلحاق الضرر بالمنتج ذاته. 6- الإضراب والمشاكل الأخرى: يعتبر الإضراب من أقوى مؤشرات عدم الرضا حدة، حيث يعبر عن التذمر وحالة من الفوضى والإهمال التي يعيشها العامل داخل المؤسسة، ويلجأ العمال إلى هذا الشكل (الإضراب) سواء كانوا في جماعة صغيرة أو كبيرة العدد، ردًا على الوضعية التي يعيشونها (الأجر المنخفض، طرق الإشراف، الترقية.. الخ) عاكسًا لطموحهم وتطلعهم إلى زيادة الأجر، تحسين ظروف العمل أو المطالبة بالتغيير وغيرها. والإضرابات لا تتسبب في الخسائر للمؤسسة فقط، بل تتسبب حتى في عدم الاستقرار لاقتصادات البلدان أيضًا.
ثانيًا: الآثار الإيجابية للرضا الوظيفي آثار إيجابية بالغة على المنظمات بشكل عام، ويمكن تلخيص أهمها في التالي: 1- تحقيق الأداء المنتج: ويقصد به قيام الفرد بالأنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله كمّا ونوعا؛ فلقد كانت العلاقة الفعلية بين الرضا الوظيفي والأداء موضوعًا لكثير من الأعمال والبحوث وموضوعًا للجدل بين المنظرين على اعتبار أن هذين المتغيرين من أهم المتغيرات التنظيمية فعالية، ولا نريد أن ندخل كثيرًا في تلك المتاهات إلا أنه يمكننا أن نقول ان الرضا يؤدي إلى تحقيق الأداء المرتفع، وفُسر ذلك بأن العامل إذا ارتفع رضاه عن عمله زاد حماسه للعمل، مما ينتج عنه إقبال وامتنان كبيران تجاه عمله، وهذا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع عمله وإنتاجيته والعكس صحيح.
كما يؤثر الأداء على الرضا، إذ عند تحقيق العامل لأداء عال في ظل نظام حوافز محدد وعادل، يحصل العامل على حوافز وعوائد نتيجة أدائه المرتفع فتزداد بذلك إشباعاته المادية من جهة وتزداد مكانته بين زملائه في المؤسسة، وهذا ما يدفع العامل إلى الشعور بالفخر والاعتزاز بالنفس من جهة أخرى وينعكس ذلك إيجابًا على درجة الرضا الوظيفي لديه.
2- الولاء التنظيمي: يعكس الولاء طبيعة الشعور لدى الأفراد تجاه مؤسساتهم ومدى تعلقهم وتوحدهم من أجل خدمتها؛ فيتأثر الولاء بدرجة الرضا تأثرًا واضحًا حيث إن الراضين عن عملهم يتصفون بالتعاون وتقوية العلاقات الاجتماعية بينهم، كما أن لديهم رغبة في الحفاظ على موارد المؤسسة وتحمل المصاعب دون شكوى – بحسب طبيعة الأشخاص– وهيكلها وهي مميزات الولاء التنظيمي.
3- الصحة العضوية والعقلية: بالإضافة إلى ما ذكر، فإن هناك آثارا أخرى وهي تلك التي تتعلق بصحة الموظف والعمال ويقصد بها الصحة العضوية من ناحية– كالتعب، صعوبة التنفس، الصداع وغيرها؛ وربما بعض من حالات القرحة – والصحة العقلية والنفسية من ناحية أخرى، حيث إن محيط العمل الجيد يبعث على ارتياح الحالة العقلية بعيدًا عن المشاكل والاضطرابات النفسية.
والخلاصة، انه من أجل القضاء على المشاكل والاضطرابات والكلام والهمس الذي يمكن أن يدور في أروقة المؤسسة علينا أن نهتم بالإنسان، قبل أن نهتم بالربح والإنتاج والأجهزة وما إلى ذلك، وإن كانت كل تلك الممتلكات مهمة وثمينة، فإن الإنسان هو العامل الحاسم في كل تلك القضية، فهو الذي يدير الأجهزة ويصنع الإنتاج ويولد استمرارية عمل المؤسسة، لذلك يجب الاهتمام بتحسين الظروف المادية المحيطة بالعامل (الإضاءة، التكييف، الحرارة، الغبار.. الخ)، وبيئة العمل الاجتماعية (العلاقات مع الرؤساء، الزملاء، الأنظمة العمالية.. الخ)، وكل ما يتعلق بواقع العمل وحاجاته ورغباته، لأن الآثار السلبية حتمًا ستؤدي إلى إضعاف المؤسسة وزيادة تكاليفها.
zkhunji@hotmail.com @Z_khunji http://www.akhbar-alkhaleej.com/13043/article/60565.html
zkhunji@hotmail.com @Z_khunji http://www.akhbar-alkhaleej.com/13043/article/60565.html